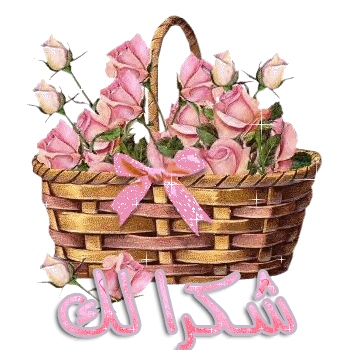أراد الله تعالى من عباده التنسك له
بالاستغفار والتوبة، والتقرب إليه بالرجوع عن الباطل متى لاحت أنوار الحق
، فكتب عليهم الخطأ، وابتلاهم بالوقوع في الزلل ، يستوي في ذلك العالم
والجاهل ، والداعية والمدعو، والفرد والجماعة. ومن النصوص المؤكدة لهذا
المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (( كل بني آدم خطّاء، وخير الخطائين
التوابون)) .، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده! لو لم
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)) .
فلابد للعبد من الوقوع في الذنب، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن المرء
لا يؤتى من فعل المعصية وإن عظمت ، وإنما يؤتى من الإصرار عليها، وترك
التوبة وتأخيرها.
وتأكيداً على هذه السجية الإنسانية فقد حفظت لنا النصوص عن أولي العز
من الرسل وهم خيرة البشرية وسادتها، وأتقاها لربها – الوقوع في بعض أنواع
السهو، وفعل خلاف الأولى ، ومخافة عاقبة بعض العمل، كما في قوله تعالى: ((
عفا الله عنك لم أذنت لهم )) التوبة : 43)، حين أذن النبي صلى الله عليه
وسلم لمن استأذنه من أهل النفاق بالتخلف عن الخروج معه إلى غزوة تبوك،
جنوحاً منه صلى الله عليه وسلم للأيسر وأخذاً منه بالأرفق ، مع أنه كان في
ترك الإذن لهم مزيد من تعريتهم وفضحهم، إذ كانوا يبيتون القعود وإن لم
يؤذن لهم بالتخلف..
وكما في قوله سبحانه : (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ، لولا كتاب
من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)) الأنفال: 67-68) ، والتي نزلت
في أسرى المشركين في بدر حين استبقاهم المسلمون لأجل الفداء مع أن المصلحة
المقتضية إبادتهم وإبطال شرهم كانت أعظم..
وكما في نزول صدر سورة عبس حين أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم
ابن أم مكتوم رضي الله عنه حين كان مشتغلاً بدعوة بعض صناديد قريش رجاء
إسلامهم، فعاتبه ربه عز وجل ليعلمه والمصلحين من أمته بأن الإقبال على
الطامع في الخير الحريص على الانقياد لرب العالمين أولى من الطمع في هداية
المعرض عن الحق وإن كان في ذلك نوع مصلحة ولا شك .
وكما في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر
ركعتين، فقال: (( يا نبي الله! أنسيت أم قصرت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
لم أنس ولم تقصر، قالوا: بل نسيت يا رسول الله ! قال صدق ذو اليدين))
وكما في حديث الشفاعة حين يأتي الناس آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى عليهم
السلام، فكل واحد منهم يذكر عملاً يخاف عاقبته، ويقول: (( نفسي نفسي!
اذهبوا إلى غيري))
ولذا حتى لا يفتر الحق ويضمحل المعروف ويشيع المنكر نتيجة سهو أو غفلة
أو ركوب هوى أو وسوسة نفس أمارة بالسوء أو تزيين شيطان؛ عظمت النصوص من
شأن النصيحة وأوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي بيئة وجد فيها
الخلل وشاع الزلل ؛ ففي سورة العصر جعل الله تعالى التواصي بالحق من ركائز
النجاة وأعمدة الفلاح ، وقال صلى الله عليه وسلم (( من رأى منكم منكراً
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف
الإيمان)). فأوجب صلى الله عليه وسلم على كل مطلع على منكر لم يغير،
ومشاهد لزلل باق المبادرة إلى إزالته وإصلاحه ، كل بحسب قدرته ، يقول
النووي : (وأما قوله (فليغيره) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة – ثلاثاً ))، ومعناه: أن
عماد الدين وقوامه التناصح ، فالسعي في الأرض بالنصيحة من أجل الأعمال ،
وأعظمها، وأحبها إلى الله تعالى، وذلك لما فيها من غشاعة الخير، والحد من
الشر، وضمان سلامة النهج، وصيانة الأمة بعامة والدعوة بخاصة عن مواقع
الردي ومواضع الهلكة.
والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده قد مارس إنكار الخطأ
مع جمع من أجلاء أصحابه الكرام رضي الله عنهم، يستوي في ذلك خطأ الفكر
وخطأ السلوك ، وخطأ الإفراط وخطأ التفريط ، وخطأ التعبد والجهاد وخطأ
المعاملة والسلوك، ومن نماذج ذلك :
ما رواه جابر – رضي الله عنه – (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول
الله ! إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب، وقال:
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! فو الذي نفسي بيده ! لقد جئتكم بها بيضاء
نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به،
والذي نفسي بيده! لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني))
وما رواه أنس – رضي الله عنه – قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما
أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل
أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء
فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني اصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) .
وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (( بعثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الحرقة ، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً
منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري ، فطعنته برمحي
حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة!
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاً . فما زال يكررها
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)) .
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردّ،
وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ، ثلاثاً ، فقال: والذي
بعثك بالحق! ما أحسن غيره فعلمني ! فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم
اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى
تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً،
وافعل ذلك في صلاتك كلها)) .
وما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: (( إني ساببت رجلاً فعيّرته بأمه،
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟! إنك امرؤ
فيك جاهلية )) .
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : (( أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه ، فطرحه ، وقال: يعمد أحدكم إلى
جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم : خذ خاتمك، انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبداً ، وقد طرحه
رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: ما هذا يا
صاحب الطعام: قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال: أفلا جعلته فوق
الطعام: كي يراه الناس، من غشّ فليس مني )) .
بل إنه صلى الله عليه وسلم تجاوز مع بعض أصحابه الكرام الإنكار إلى
التوجيه لإتيان الأفضل وفعل ما هو أولى، كما في حديث ابن عمر رضي الله
عنهما : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان
يقوم من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً ) .
ففي شيوع ثقافة التناصح المسؤول والاحتساب المنضبط وإزالة العوائق أمام
النقد الإيجابي البناء في أوساط العلماء والدعاة وأهل الخير؛ ترشيد للصحوة
المباركة ، وتعزيز للانضباط الشرعي داخلها ، وضمان لسلامة النهج ، وتأصيل
لمبدأ الدوران مع الحق حيث دار، وافق المرء فيه من وافق وخالفه من خالف،
وحيلولة دون التمادي في الباطل واتساع خط الانحراف وزاوية الخطأ.
والمتأمل في واقع الطيف العامل للإسلام اليوم على اختلاف جوانب
اهتماماته: علمية كانت أو تربوية أو اجتماعية أو سياسية أو جهادية أو
مهمته بتهذيب الأخلاق وتزكية النفس – على الخير العميم الذي نتج عن تلك
الجهود في الجملة – يجد بعضها واقعاً في أخطاء جسمية وانحرافات فكرية أو
عملية خطرة – إفراطاً أو تفريطاً – تكاد تعصف بالمسيرة وتنحرف بأصحابها عن
الجادة ، بل إن الأثر ليتجاوز في أحيان كثيرة أصحابه إلى إقحام الأمة كلها
في مقاوز مهلكة ، ودركات من التهور والردي غير محسوبة – مهما حسنت النية –
مما زادها ضعفاً إلى ضعف، وهواناً إلى هوان، وكل ذلك ما كان له أن يحدث لو
بودر بالنصح ومورس النقد البناء بكل شجاعة وإيجابية من كل عالم قادر، أول
ما ابتدأ الانحراف ووقع الزلل ، قبل أن يتجذر الخطأ ويشتد عوده، فيتعسر
الحل ويتأبى الواقع غير المرغوب فيه والمشوب في أحيان كثيرة بحق أو بشبهة
حق – عن العلاج ، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
والإشكال أن الواقع الدعوي المعاصر يعاني في هذا الجانب من إفراط
وتفريط ؛ فمن تعيير باسم النصيحة ، وفضيحة باسم احتساب لا يحفظ حقوق
الأخوة ولا يراعي مقاصد الشريعة ويتفلت من ضوابطها ، إلى ترك للمناصحة
والإنكار بالكلية؛ زعماً بخشية الفتنة، وإيثاراً للسلامة، وحفاظاً على
وحدة الصف الدعوي، ومخافة من فتح مجال أمام أعداء الدعوة يمكنهم من خلاله
ممارسة مزيد من الهمز والتطاول والتشويه!
إن الغفلة عن شمولية النصوص الواردة في التحذير من ترك الاحتساب لداخل
البناء الدعوي وخارجه: كقوله تعالى: (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصو وكانوا يعتدون، كانوا لا
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)) المائدة 78- 79.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه
أوشك الله أن يعمهم بعقابه) ، وتناسي الآثار الجسيمة الناجمة عن ضعف
التناصح داخل البيئات العلمية والدعوية.. كل ذلك هو مفتاح شر عظيم، وبوابة
هلكة، وعين فتنة، وخرق كبير مغرق للسفينة، إذ كم جرت الذنوب من خطوب ،
وأورثت المعاصي أصحابها من عطوب ، والتاريخ ماضية وحاضرة خير شاهد، ويكفي
من ذلك أن العثرة التي وقع فيها الجيش النبوي في غزوة أحد كان سببها
مخالفة واحدة تمثلت بمخالفة الرماة أمره صلى الله عليه وسلم لهم بعدم
النزول عن الجبل ومفارقة مكانهم الذي هم فيه ولو رأوا الطير تتخطف
العسكر.،وأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتلى، فقال: (( ولقد صدقكم
الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين )). آل عمران 152
ومن المهم التأكيد على أن التناصح ليس ضرورة فحسب لتصحيح أمراض ماضية،
إذ إننا ما فتنا نرى في كل فترة وجيزة من الزمن مشروعات تقام ومؤسسات تنهض
مرتكزة على نوايا حسنة وهمم عالية ورغبة عارمة في نهوض الأمة من كبوتها
المؤلمة، لكن بعضها قد تنقصه الرؤية الواضحة والضوابط الموجهة والمعرفة
الشرعية المتعمقة والتي تحميه من مواقع الخطل وبؤر الفتن، مما تبرز معه
أهمية النصيحة المسبقة ، منعاً للزلل قبل وقوعه، أو لإزالته وهو ما يزال
في بداية حدوثه.
ولذا فلابد أن يكون للعالم الرباني كانته ولذي الخبرة والاختصاص المحيط
بمجريات الواقع منزلته ، وأن يكون للتناصح أولويته وآلياته المشجعة على
القيام به داخل سياج أمتنا العلمي والدعوي متى أريد للانطلاقة مزيدٌ من
الصواب ، وللثمار مزيد من النفع والتقبل.
فاللهم ثبتنا على ما تحب يا كريم ، واحفظ علينا ديننا ، ووفقنا
والمصلحين فينا لما فيه سعادتنا وخير أمتنا وسداد دعوتنا ، بمن منك وإحسان
يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه
أجمعين.
منقول
بالاستغفار والتوبة، والتقرب إليه بالرجوع عن الباطل متى لاحت أنوار الحق
، فكتب عليهم الخطأ، وابتلاهم بالوقوع في الزلل ، يستوي في ذلك العالم
والجاهل ، والداعية والمدعو، والفرد والجماعة. ومن النصوص المؤكدة لهذا
المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (( كل بني آدم خطّاء، وخير الخطائين
التوابون)) .، وقوله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده! لو لم
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)) .
فلابد للعبد من الوقوع في الذنب، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن المرء
لا يؤتى من فعل المعصية وإن عظمت ، وإنما يؤتى من الإصرار عليها، وترك
التوبة وتأخيرها.
وتأكيداً على هذه السجية الإنسانية فقد حفظت لنا النصوص عن أولي العز
من الرسل وهم خيرة البشرية وسادتها، وأتقاها لربها – الوقوع في بعض أنواع
السهو، وفعل خلاف الأولى ، ومخافة عاقبة بعض العمل، كما في قوله تعالى: ((
عفا الله عنك لم أذنت لهم )) التوبة : 43)، حين أذن النبي صلى الله عليه
وسلم لمن استأذنه من أهل النفاق بالتخلف عن الخروج معه إلى غزوة تبوك،
جنوحاً منه صلى الله عليه وسلم للأيسر وأخذاً منه بالأرفق ، مع أنه كان في
ترك الإذن لهم مزيد من تعريتهم وفضحهم، إذ كانوا يبيتون القعود وإن لم
يؤذن لهم بالتخلف..
وكما في قوله سبحانه : (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ، لولا كتاب
من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)) الأنفال: 67-68) ، والتي نزلت
في أسرى المشركين في بدر حين استبقاهم المسلمون لأجل الفداء مع أن المصلحة
المقتضية إبادتهم وإبطال شرهم كانت أعظم..
وكما في نزول صدر سورة عبس حين أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم
ابن أم مكتوم رضي الله عنه حين كان مشتغلاً بدعوة بعض صناديد قريش رجاء
إسلامهم، فعاتبه ربه عز وجل ليعلمه والمصلحين من أمته بأن الإقبال على
الطامع في الخير الحريص على الانقياد لرب العالمين أولى من الطمع في هداية
المعرض عن الحق وإن كان في ذلك نوع مصلحة ولا شك .
وكما في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر
ركعتين، فقال: (( يا نبي الله! أنسيت أم قصرت ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
لم أنس ولم تقصر، قالوا: بل نسيت يا رسول الله ! قال صدق ذو اليدين))
وكما في حديث الشفاعة حين يأتي الناس آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى عليهم
السلام، فكل واحد منهم يذكر عملاً يخاف عاقبته، ويقول: (( نفسي نفسي!
اذهبوا إلى غيري))
ولذا حتى لا يفتر الحق ويضمحل المعروف ويشيع المنكر نتيجة سهو أو غفلة
أو ركوب هوى أو وسوسة نفس أمارة بالسوء أو تزيين شيطان؛ عظمت النصوص من
شأن النصيحة وأوجبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي بيئة وجد فيها
الخلل وشاع الزلل ؛ ففي سورة العصر جعل الله تعالى التواصي بالحق من ركائز
النجاة وأعمدة الفلاح ، وقال صلى الله عليه وسلم (( من رأى منكم منكراً
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف
الإيمان)). فأوجب صلى الله عليه وسلم على كل مطلع على منكر لم يغير،
ومشاهد لزلل باق المبادرة إلى إزالته وإصلاحه ، كل بحسب قدرته ، يقول
النووي : (وأما قوله (فليغيره) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة – ثلاثاً ))، ومعناه: أن
عماد الدين وقوامه التناصح ، فالسعي في الأرض بالنصيحة من أجل الأعمال ،
وأعظمها، وأحبها إلى الله تعالى، وذلك لما فيها من غشاعة الخير، والحد من
الشر، وضمان سلامة النهج، وصيانة الأمة بعامة والدعوة بخاصة عن مواقع
الردي ومواضع الهلكة.
والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده قد مارس إنكار الخطأ
مع جمع من أجلاء أصحابه الكرام رضي الله عنهم، يستوي في ذلك خطأ الفكر
وخطأ السلوك ، وخطأ الإفراط وخطأ التفريط ، وخطأ التعبد والجهاد وخطأ
المعاملة والسلوك، ومن نماذج ذلك :
ما رواه جابر – رضي الله عنه – (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول
الله ! إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب، وقال:
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! فو الذي نفسي بيده ! لقد جئتكم بها بيضاء
نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به،
والذي نفسي بيده! لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني))
وما رواه أنس – رضي الله عنه – قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما
أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل
أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء
فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني اصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) .
وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (( بعثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى الحرقة ، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً
منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري ، فطعنته برمحي
حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة!
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاً . فما زال يكررها
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)) .
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردّ،
وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ، ثلاثاً ، فقال: والذي
بعثك بالحق! ما أحسن غيره فعلمني ! فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم
اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى
تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً،
وافعل ذلك في صلاتك كلها)) .
وما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: (( إني ساببت رجلاً فعيّرته بأمه،
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟! إنك امرؤ
فيك جاهلية )) .
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : (( أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه ، فطرحه ، وقال: يعمد أحدكم إلى
جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم : خذ خاتمك، انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبداً ، وقد طرحه
رسول الله صلى الله عليه وسلم)) .
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال: ما هذا يا
صاحب الطعام: قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال: أفلا جعلته فوق
الطعام: كي يراه الناس، من غشّ فليس مني )) .
بل إنه صلى الله عليه وسلم تجاوز مع بعض أصحابه الكرام الإنكار إلى
التوجيه لإتيان الأفضل وفعل ما هو أولى، كما في حديث ابن عمر رضي الله
عنهما : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان
يقوم من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً ) .
ففي شيوع ثقافة التناصح المسؤول والاحتساب المنضبط وإزالة العوائق أمام
النقد الإيجابي البناء في أوساط العلماء والدعاة وأهل الخير؛ ترشيد للصحوة
المباركة ، وتعزيز للانضباط الشرعي داخلها ، وضمان لسلامة النهج ، وتأصيل
لمبدأ الدوران مع الحق حيث دار، وافق المرء فيه من وافق وخالفه من خالف،
وحيلولة دون التمادي في الباطل واتساع خط الانحراف وزاوية الخطأ.
والمتأمل في واقع الطيف العامل للإسلام اليوم على اختلاف جوانب
اهتماماته: علمية كانت أو تربوية أو اجتماعية أو سياسية أو جهادية أو
مهمته بتهذيب الأخلاق وتزكية النفس – على الخير العميم الذي نتج عن تلك
الجهود في الجملة – يجد بعضها واقعاً في أخطاء جسمية وانحرافات فكرية أو
عملية خطرة – إفراطاً أو تفريطاً – تكاد تعصف بالمسيرة وتنحرف بأصحابها عن
الجادة ، بل إن الأثر ليتجاوز في أحيان كثيرة أصحابه إلى إقحام الأمة كلها
في مقاوز مهلكة ، ودركات من التهور والردي غير محسوبة – مهما حسنت النية –
مما زادها ضعفاً إلى ضعف، وهواناً إلى هوان، وكل ذلك ما كان له أن يحدث لو
بودر بالنصح ومورس النقد البناء بكل شجاعة وإيجابية من كل عالم قادر، أول
ما ابتدأ الانحراف ووقع الزلل ، قبل أن يتجذر الخطأ ويشتد عوده، فيتعسر
الحل ويتأبى الواقع غير المرغوب فيه والمشوب في أحيان كثيرة بحق أو بشبهة
حق – عن العلاج ، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
والإشكال أن الواقع الدعوي المعاصر يعاني في هذا الجانب من إفراط
وتفريط ؛ فمن تعيير باسم النصيحة ، وفضيحة باسم احتساب لا يحفظ حقوق
الأخوة ولا يراعي مقاصد الشريعة ويتفلت من ضوابطها ، إلى ترك للمناصحة
والإنكار بالكلية؛ زعماً بخشية الفتنة، وإيثاراً للسلامة، وحفاظاً على
وحدة الصف الدعوي، ومخافة من فتح مجال أمام أعداء الدعوة يمكنهم من خلاله
ممارسة مزيد من الهمز والتطاول والتشويه!
إن الغفلة عن شمولية النصوص الواردة في التحذير من ترك الاحتساب لداخل
البناء الدعوي وخارجه: كقوله تعالى: (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل
على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصو وكانوا يعتدون، كانوا لا
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)) المائدة 78- 79.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه
أوشك الله أن يعمهم بعقابه) ، وتناسي الآثار الجسيمة الناجمة عن ضعف
التناصح داخل البيئات العلمية والدعوية.. كل ذلك هو مفتاح شر عظيم، وبوابة
هلكة، وعين فتنة، وخرق كبير مغرق للسفينة، إذ كم جرت الذنوب من خطوب ،
وأورثت المعاصي أصحابها من عطوب ، والتاريخ ماضية وحاضرة خير شاهد، ويكفي
من ذلك أن العثرة التي وقع فيها الجيش النبوي في غزوة أحد كان سببها
مخالفة واحدة تمثلت بمخالفة الرماة أمره صلى الله عليه وسلم لهم بعدم
النزول عن الجبل ومفارقة مكانهم الذي هم فيه ولو رأوا الطير تتخطف
العسكر.،وأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتلى، فقال: (( ولقد صدقكم
الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين )). آل عمران 152
ومن المهم التأكيد على أن التناصح ليس ضرورة فحسب لتصحيح أمراض ماضية،
إذ إننا ما فتنا نرى في كل فترة وجيزة من الزمن مشروعات تقام ومؤسسات تنهض
مرتكزة على نوايا حسنة وهمم عالية ورغبة عارمة في نهوض الأمة من كبوتها
المؤلمة، لكن بعضها قد تنقصه الرؤية الواضحة والضوابط الموجهة والمعرفة
الشرعية المتعمقة والتي تحميه من مواقع الخطل وبؤر الفتن، مما تبرز معه
أهمية النصيحة المسبقة ، منعاً للزلل قبل وقوعه، أو لإزالته وهو ما يزال
في بداية حدوثه.
ولذا فلابد أن يكون للعالم الرباني كانته ولذي الخبرة والاختصاص المحيط
بمجريات الواقع منزلته ، وأن يكون للتناصح أولويته وآلياته المشجعة على
القيام به داخل سياج أمتنا العلمي والدعوي متى أريد للانطلاقة مزيدٌ من
الصواب ، وللثمار مزيد من النفع والتقبل.
فاللهم ثبتنا على ما تحب يا كريم ، واحفظ علينا ديننا ، ووفقنا
والمصلحين فينا لما فيه سعادتنا وخير أمتنا وسداد دعوتنا ، بمن منك وإحسان
يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه
أجمعين.
منقول

 السبت أبريل 23, 2011 2:16 pm من طرف AHMED
السبت أبريل 23, 2011 2:16 pm من طرف AHMED
 Ahlamontada
Ahlamontada